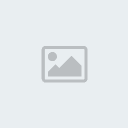لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ (28)
من حقائقِ الإيمانِ المُوالاةُ في اللهِ والمُعاداةُ في اللهِ، قال ابنُ عبَّاسٍ رضي الله عنهما: كان الحَجَّاجُ بنُ عَمْرٍو. وكَهمس بنُ أبي الحقيقِ وقيس بن زيد وهم جميعًا من اليهود يباطنون نَفَراً مِن الأنصارِ لِيَفتُنوهم عن دينهم، فقالَ رِفاعةُ بنُ المُنذر وعبد الله بن جبَيْرٍ وسعيد بن خيثمة لأولئك النفر: اجتنبوا هؤلاءِ اليهود واحذروا لُزومَهم ومباطَنَتَهم لا يَفتنوكم عن دينِكم فأبوا فأنزلَ اللهُ هذه الآيةَ، وقال الكلبي: نَزَلت في المُنافقين عبدِ اللهِ بنِ أُبِيٍّ وأصحابِه كانوا يَتولَّوْن اليهودَ والمُشركين ويَأتونَهم بالأخبار ويرجون أنْ يَكونَ لَهم الظَّفرُ على رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلَّم فأنزلَ اللهُ تعالى الآيةَ ونهى المؤمنين عن فعلهم. وروى الضحاك عن ابن عباس أنَّها نَزَلت في عُبادةَ بنِ الصامِتِ الأَنصارِي وكان بدريًّا نقيًّا، وكان له حلفاء مِن اليهود فلمَّا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب قال عبادة: يا نبيَّ اللهِ معي خَمْسُمِئةٍ من اليهودِ وقد رأيتْ أنْ يَخرجوا معي فاستظهِر بهم على العدو فأنزل اللهُ تعالى {لاَّ يَتَّخِذِ} الخ، المعنى على النهي والمُرادُ أن يراعوا ما هم عليه مما يَقتضيه الإسلام مِن بُغْضٍ وحُبٍّ شرعيَّيْن يَصِحُّ التَكليفُ بهما وإنَّما قيَّدنا بذلك لما قالوا: إنَّ المَحَبَّةَ لِقرابةٍ أو صَداقةٍ قديمةٍ أو جَديدةٍ خارِجةٍ عن الاختيارِ مَعْفُوَّةٍ ساقطةٍ عن درجةِ الاعتبار، وحَمْلُ المُوالاةِ على ما يَعُمَّ الاستعانةَ بهم في الغزو مما ذهب إليه البعضُ وما عليه الجمهور أنَّه إنَّما يُستَعانُ بهم على قتال المشركين لا البغاة على ما صرحوا به، وما رُوي عن السيدة عائشة رضيَ اللهُ تعالى عنها أنها قالت: خرج رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِبدرٍ فتبِعَه رجلٌ مشركٌ كان ذا جَراءَةٍ ونجدةٍ ففرح أصحابُ النبيِّ صلى الله عليه وسلَّم حين رأوه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ((ارْجِعْ فلن أِستعينَ بِمُشرك)) فمَنسوخٌ بأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلَّم استعان بيهودِ بني قَيْنُقاع واستعان بصفوان بنِ أُميَّةَ في هَوازن، وذكرَ بعضُهم جوازَ الاستعانةِ بشرطِ الحاجةِ والوُثوقِ أمَّا بِدونِهما فلا تَجوزُ، وعلى ذلك يُحمَلُ خبرَ عائشةَ، وكذا ما رواه الضَّحَّاكُ عن ابنِ عبَّاسٍ في سببِ النُّزولِ وبِه يَحصُلُ الجمعُ بيْن أَدِلَّةِ المَنْعِ وأَدِلَّةِ الجَوازِ على أنَّ بعضَ المُحقِّقين ذَكَرَ أنَّ الاستعانةَ المَنْهي عنْها إنَّما هي استعانةُ الذليلِ بالعزيزِ وأمَّا إذا كانت من بابِ استعانةِ العزيزِ بالذليلِ فقد أُذِنَ لنا بها، ومِن ذلك اتِّخاذُ الكُفَّارَ عَبيدًا وخَدَمًا ونِكاحُ الكِتابيَّاتِ منهم وهو كلامٌ حَسَنٌ كما لا يخفى. ومِن النَّاسِ مَنِ اسْتَدَلَّ بالآيةِ على أنَّه لا يَجوزُ جعلُهم عُمَّالاً ولا اسْتِخدامُهم في أُمورِ الديوان وغيرِهِ وكذا أُدْخِلوا في المُوالاةِ المَنْهي عنها السلامُ والتعظيمُ والدعاءُ بالكُنْيةِ والتوقيرُ بالمَجالِس، وفي "فتاوى العلامةِ ابنِ حَجَرٍ" جَوازَ القِيامِ في المَجلس لأهلِ الذِمَّةِ وعَدَّ ذلك من بابِ البِرِّ والإحسانِ المَأذونِ به في قوله تعالى: {لاَّ ينهاكم الله عَنِ الذين لَمْ يقاتلوكم فِي الدين وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مّن دياركم أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُواْ إِلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ المُقسِطين} الممتحنة: 8.
قولُه: {مِن دُونِ المؤمنين} أي متجاوزين المؤمنين إلى الكافرين استقلالاً أو اشتِراكاً ولا مفهوم لهذا الظرف إما لأنه ورد في قوم بأعيانهم والوا الكفار دون المؤمنين فهو لِبيانِ الواقِعِ أو لأنَّ ذِكرَه للإشارةِ إلى أنَّ الحقيقَ بالمُوالاةِ همُ المؤمنون وفي مُوالاتِهم مَندوحةٌ عن مُوالاةِ الكُفَّارِ. قوله: {وَمَن يَفْعَلْ ذلك} أي الاتخاذ {فَلَيْسَ مِنَ الله فِي شَيءٍ} أي من ولايتِه، أو من دينِه، و{شيء} للتحقيرِ أيْ ليس في شيءٍ يَصحُّ أنْ يُطلَقَ عليه اسمُ الوِلايَةِ أوْ الدِّين.
وقوله تعالى: {شَيء إِلَّا أَن تَتَّقُواْ} على صِيغة الخطابِ بطريقِ الغيْبةِ استثناءٌ مُفَرَّغٌ مِن أَعَمِّ الأحوالِ والعاملُ فيه فعلُ النَّهْيِ مُعتَبِراً فيه الخطابَ أي لا تتَّخِذوهم أولياءَ في حال من الأحوالِ إلَّا حالَ اتَّقائكم، وقيل أي لا يَتَّخِذَ المؤمنُ الكافرَ وليًّا لشيءٍ مِن الأشياءِ إلَّا للتَّقِيَّةِ {مِنْهُمْ} أي من جِهتِهم؛ والمُرادُ بالتُّقاةِ ما يُتَّقى منه وتكون بمعنى اتِّقاء وهو الشائع.
وفي الآيةِ دليلٌ على مَشروعيَّةِ التَّقِيَّةِ وعرَّفوها بمُحافظةِ النفسِ أو العِرْضِ أوِ المالِ مِن شرِّ الأعداءِ، والعدوُّ قِسمان: الأوَّلُ: مَن كانت عداوَتُه مَبنِيَّةً على اختلافِ الدين كالكافِر والمُسلم، والثاني: مَنْ كانت عداوتُه مَبنيَّةً على أَغراضٍ دُنْيَوِيَّةٍ كالمالِ والمَتاعِ والمُلْكِ والإِمارةِ، ومِن هنا صارت التَّقِيَّةُ قسميْن: أمّا القسمُ الأوَّلُ: فالحُكْمُ الشَرْعيُّ فيه أنَّ كلَّ مُؤمِنٍ وَقَعَ في مَحَلٍّ لا يُمكِنُ لَه أنْ يُظهِرَ فيه دِينَه لِتَعَرُّضِ المُخالفين وَجَبَ عليه الهِجرةُ إلى مَحَلٍّ يَقدِرُ فيه على إِظهارِ دينِه ولا يَجوزُ لَه أَصْلاً أنْ يَبقى هناك ويُخفي دينَه ويَتَشَبَّث بعذرِ الاستضعافِ فإنَّ أرضَ اللهِ تعالى واسعةٌ، نعم إنْ كان ممَّن لهم عُذْرٌ شرعيٌّ في تَرْكِ الهِجرة كالصِبيان والنِّساءِ والعُميانِ والمَحبوسين والذين يُخوِّفُهم المُخالفون بالقَتْلِ أو قتلِ الأولادِ أو الآباءِ أو الأُمَّهاتِ تَخويفاً يُظَنُّ معه إيقاعُ ما خُوِّفوا بِه غالِباً سواءً كان هذا القتلُ بضربِ العُنُقِ أو بِحَبْسِ القُوتِ أوْ بِنَحْوِ ذلك فإنَّه يَجوزُ له المُكْثُ مع المُخالِفِ والمُوافَقةُ بقدْرِ الضَّرورةِ ويجب عليه أنْ يَسعى في الحيلةِ للخُروجِ والفرارِ بِدينِه ولو كان التخويف بفواتِ المَنفَعَةِ أو بلُحوقِ المَشَقَّةِ التي يُمكِنُه تَحَمُّلُها لا يَجوزُ له موافقتُهم، وفي صورة الجوازِ أيضاً موافقتُهم رُخصَةً وإظهارُ مذهبِه عزيمةً فلو تَلِفتْ نفسُه لذلك فإنّه شهيدٌ قَطْعاً، وممّا يَدُلُّ على أنَّها رُخصةٌ ما رُويَ أنَّ مُسيْلَمةَ الكذابَ أخذَ رَجُليْن مِن أصحابِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقال لأحدِهما: أَتَشْهَدُ أنَّ مُحمَّداً رسولُ اللهِ؟ قال: نعم، فقال: أَتشهدُ أَنِّي رسولُ اللهِ؟ قال: نعم ثمَّ دعا بالآخر فقال له: أَتَشهدُ أنَّ محمَّداً رسولُ اللهِ؟ قال: نعم، فقال: أَتشهدُ أنّي رسولُ اللهِ؟ قال: إنّي أصمّ قالَها ثلاثاً، وفي كلٍّ يُجيبُه بأنِّي أَصَمٌّ فضَرَبَ عُنُقَه فبَلَغَ ذلك رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقال: ((أمَّا هذا المَقتولُ فقد مَضى على صِدْقِه ويَقينِه وأَخذَ بِفضلِه فهنيئًا له. وأمّا الآخرُ فقد رَخَّصَه اللهُ تعالى فلا تَبِعَةَ عليه)). وأمّا القسم الثاني: فقد اختلَفَ العُلَماءُ في وُجوبِ الهِجرةِ وعدمِه فيه فقال بعضُهم: تَجِبُ لقولِه تعالى: {وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التهلكة} البقرة: 195 وبدليلِ النهيِ عن إضاعةِ المال، وقال قوم: لا تَجِبُ إذ الهِجرةُ عن ذلك المَقامِ مصلحةٌ مِن المَصالحِ الدنيويَّةِ ولا يَعودُ مِن تركِها نُقصانٌ في الدِينِ لاتِّحادِ المِلَّةِ وعَدُوُّهُ القويُّ المؤمِنُ لا يتعرَّضُ له بالسوءِ مِن حيثُ هو مؤمنٌ، وقال بعضُهم: الحقُّ أنَّ الهجرةَ هنا قد تجب أيضاً إذا خاف هلاكَ نفسِه أو أقارِبِه أو هتْكَ حُرمتِه بالإفْراطِ ولكن ليست عبادةً وقُربةً حتّى يَترتَّبَ عليها الثوابُ فإنَّ وُجوبَها لِمَحْضِ مَصلَحَةٍ دنيويَّةٍ لذلك المُهاجِرِ لا لإصلاحِ الدِّين ليترتَّبَ عليها الثوابُ وليس كلُّ واجبٍ يُثابُ عليه لأنَّ التحقيقَ أنَّ كلَّ واجبٍ لا يكون عبادةً بلْ كثيرٌ مِن الواجبات ما لا يترتَّبُ عليه ثوابٌ كالأَكْلِ عندَ شدَّةِ المَجاعةِ والاحترازِ عن المُضرّاتِ المَعلومَةِ أو المَظنونَةِ في المرض، وهذه الهجرة أيضاً من هذا القبيل وليست هي كالهجرة إلى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لتكون مستوجبةً فضلَ الله تعالى وثوابَ الآخرة.
قولُهُ تعالى: {لا يَتَّخِذِ المؤمنون} العامَّة على قراءتِهِ نهياً، وقرأَ الضَبِّي: "لا يتَّخِذُ" برفعِ الدال نفيًا بمعنى لا ينبغي، أو هو خبر بمعنى النهي نحو: {لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ} البقرة: 233 و{وَلاَ يُضَآرَّ كَاتِبٌ} البقرة: 282 فيمن رفع الراء. وأجاز الكسائي رفعَ الراء على الخبر، والمعنى: لا ينبغي. وهذا موافِقٌ لِما قاله الفراء، فإنّه قال: ولو رُفع على الخبرِ كقراءةِ مَنْ قرأ: "لا تضارُّ والدة" جاز. قال أبو إسحاق: ويكون المعنى على الرفعِ أنَّه مَنْ كان مؤمناً فلا ينبغي أن يَتَّخِذَ الكافرُ ولياً. كأنَّهما لم يَطَّلِعا على قراءةِ الضبّي، أو لم تَثْبُتْ عندهما. و"يَتَّخِذُ" يَجوزُ أنْ تَكونَ المُتعدِّيةَ لواحدٍ فيكونُ "أولياء" حالاً، وأنْ تكونَ المتعدِّية لاثنين، و"أولياء" هو الثاني.
قوله: {مِن دُونِ المؤمنين} فيه وجهان، أظهرهُما: أنَّ "مِنْ" لابتداءِ الغايةِ، وهي متعلِّقةٌ بفعلِ الاِّتخاذ. أي لا تَجْعَلُوا ابتداءَ الولايةِ من مكانٍ دونَ مكانِ المؤمنين. والثاني أن يكونَ في موضِعِ نصبٍ صفةً لأولياء، فعلى هذا يتعلَّقُ بمحذوفٍ.
قولُه: {وَمَن يَفْعَلْ ذلك} أدغم الكسائي اللامَ في الذالِ هنا في روايةِ الليثِ عنه.
قولُه: {مِنَ الله في شيءٍ} الظاهِرُ أنَّه في مَحَلِّ نصبٍ على الحالِ مِن "شيء" لأنّه لو تأخَّرَ لَكانَ صِفةً له. و"في شيء" هو خبرُ ليس، لأنَّ به تستقلُّ فائدةُ الإِسناد، والتقدير: فليس في شيءٍ كائنٍ مِن الله، ولا بدَّ مِن حذفِ مضافٍ أي: فليس مِنَ وِلايَةِ اللهِ، وقيل: مِنْ دِينِ اللهِ. ونَظَّرَ بعضُهم الآيةَ الكريمةَ ببيتِ النابغة:
إذا حاوَلْتَ في "أسدٍ" فُجُوراً .............. فإنِّي لَسْتُ منك ولَسْتَ مِنِّي
قولُه: {إِلاَّ أَن تَتَّقُواْ} هذا استثناءٌ مفرَّغٌ من المَفعولِ مِن أجلِه، والعامل فيه: لا يَتَّخِذُ أي: لا يَتَّخِذُ المؤمنُ الكافرَ وليًّا لشيءٍ من الأشياء إلَّا للتَقِيَّةٍ ظاهراً، أي يكونُ مُواليَه في الظاهرِ ومعادِيَه في الباطن، وعلى هذا فقولُه: {وَمَن يَفْعَلْ ذلك} وجوابُهُ معترضٌ بين العلة ومعلولِها.
وفي قوله: {إِلاَّ أَن تَتَّقُواْ} التفاتٌ من غيبة إلى خطاب، ولو جرى على سَنَنِ الكلام الأولِ لَجاءَ بالكلامِ غيبةً، وأَبْدَوا للالتفاتِ هنا معنًى حسناً: وذلك أنَّ مُوالاةَ الكُفَّارِ لَمَّا كانت مستقبحةً لم يُواجِهِ اللهُ عبادَه بخطابِ النهي، بل جاء به في كلام أُسْنِدَ الفعل المنهيُّ عنه لغيبٍ، ولَمَّا كانَتِ المُجامَلَةُ في الظاهرِ والمُحاسَنةُ جائزةً لِعُذْرٍ وهو اتِّقاءُ شرِّهم حَسُنَ الإِقبالُ إليهم وخطابُهم بِرَفْعِ الحَرَجِ عنهم في ذلك.
قولُه: {تُقَاةً} في نَصْبِها ثلاثةُ أَوْجُهٍ وذلك مَبْنيٌّ على تَفسيرِ "تقاة" ما هي؟ أحدُها: أنَّها مَنصوبةٌ على المَصدَرِ والتقديرُ: تَتَّقوا منهم اتِّقاءً، فـ "تُقاة" واقعةٌ موقِعَ الاتِّقاءِ، والعربُ تأتي بالمَصادِرِ نائبةً عن بعضِها، والأصل: أن تتَّقوا اتِّقاءً، نحو: تقتَدِروا اقْتِداراً، ولكنَّهم أَتَوْا بالمَصدَرِ على حذفِ الزَّوائدِ كقولِه: {أَنبَتَكُمْ مِّنَ الأرض نَبَاتاً} نوح: 17 والأصلُ إنبات ومثله قول القطامي يمدح زفر ابن الحارث الكلابي:
أَكُفْراً بَعْدَ رَدِّ الْمَوْتِ عَنِّي .................... وبعدَ عطائِك المئةَ الرَّتاعا
أي: إعطائك، ومن ذلك أيضاً قولُه (القطامي):
وخَيْرُ الأمرِ ما اسْتَقْبَلْتَ منه ..................... وليس بأَنْ تَتَبَّعَهُ اتِّباعا
قول الآخر:
ولاحَ بجانب الجبلين منه .................... رُكامٌ يَحْفِرُ الأرضَ احتفارا
وهكذا عَكَسَ الآيةَ، إذا جاءَ بالمَصدَرِ مُزاداً فيه، والفعل الناصِب لَه مُجرَّد من تلك الزوائد. ومن مَجيءِ المَصدرِ على غيرِ المصدرِ قولُه تعالى: {وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً} المزمل: 8، والأصلُ تَبَتُّلاً، ومثله قولُ رُؤبة:
وقد تَطَوَّيْتُ انطواءَ الحِضْبِ ..................... بَيْنَ قَتَادِ رَدْهَةٍ وشِقْبِ
والأصلُ: تَطَوِّياً، وأَصلُ "تُقاة": "وُقَيَة" مصدرٌ على فُعَل من الوقاية، وقد تقدَّم تفسيرُ هذه المادَّةِ في أوَّلِ هذا الموضوع، ثمَّ أُبْدلت الواوُ تاءً، ومثلُها تُخَمَة وتُكَاة وتُجاه، وتَحَرَّكتْ الواوُ وانفتحَ ما قبلَها فَقُلِبت ألفاً، فصارَ اللفظُ "تُقاة"، كما ترى، ووزنُها فُعَلة، ومجيءُ المَصدرِ على فُعَل وفُعَلة قليل نحو: التُّخَمة والتُّهَمة والتُّؤَدة والتكَأَة، وانضمَّ إلى ذلك كونُها جاءت على غيرِ المصدر، والكثيرُ مجيءُ المَصدرِ جاريةً على أفعالِها قيل: وحَسَّنَ مجيءَ هذا المصدرِ ثلاثيًّا كونُ "فُعَلة" قد حُذِفتْ زوائدُه في كثيرٍ مِنْ كلامِهم نحو: تَقَى يَتْقِي ومنه قولُ عبد الله بن همام السلولي:
زِيادَتَنا نُعْمانُ لا تَحْرِمَنَّنا ................ تَقِ اللهَ فينا والكتابَ الذي تتلو
وقد قَدَّمُتْ تحقيق ذلك في أول البقرة.
الثاني: أنَّها منصوبةٌ على المفعولِ به، وذلك أنْ يكونَ "تَتَّقوا" بمعنى تخافوا، ويكون "تُقاة" مصدراً واقعاً موقعَ المفعولِ به. وقُرئ "تَقِيَّة"، وقيل للمُتَّقي: تُقاة وتَقِيَّة كقولهم: ضَرْبُ الأميرِ"لِمَضْروبِه". فصار تقديرُ الكلام: إلَّا أنْ تَخافوا منهم أمراً مُتَّقَىً. الثالث: أنَّها منصوبةٌ على الحالِ وصاحبُ الحالِ فاعلُ "تتَّقوا" وعلى هذا تكونُ حالاً مؤكَّدةً، لأنَّ معناه مفهومٌ من عامِلِها كقوله: {وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيّاً} مريم: 33 {وَلاَ تَعْثَوْاْ فِي الأرض مُفْسِدِينَ} البقرة: 60، وهو على هذا جمعُ "فاعِل" وإن لم يُلْفظ بفاعل من هذه المادة فيكون فاعلاً وفُعَلَة نحو: رامٍ ورُماةٌ وغازٍ وغُزاةٌ، لأنَّ فِعلَه يَطَّرِدُ جَمعاً لِفاعِلِ الوَصْفِ المُعْتَلِّ اللامِ، وقيل: بل فُعَلَة جمعٌ لفعيل.
وقرأَ ابنُ عبَّاسٍ ومُجاهدٌ وأبو رجاء وقتادة وأبو حَيَوةٍ ويَعقوبُ وسهلٌ وعاصمٌ في رِوايَةِ المُفضَّلِ عنه: "تَتَّقوا منهم تَقِيَّة" بوزن "مَطِيًّة" وهي مصدرٌ أيضاً بمعنى "تُقَاة"، يقال: اتّقى يتَّقي اتِّقاءً وتَقْوَى وتُقاة وتَقِيَّة وتُقَىً، فيَجيءُ مصدرُ افْتَعلَ مِن هذه المادَّةِ على الافتِعال وعلى ما ذُكِرَ معه مِن هذه الأَوزان، ويُقالُ أيضًا: تَقَيْتُ أَتْقي ثلاثيًّا تَقِيَّة وتَقْوى وتُقاة وتُقَىً، والياء في جميعِ هذه الألفاظ بدلٌ من الواو لما عرفته من الاشتقاق.
وأَمَالَ الأَخوانِ "تُقاة" هنا، لأنَّ ألِفَها مُنقلبةٌ عن ياءٍ كما تقدَّمَ تقريرُه، ولم يؤثِّرْ حرفُ الاسْتِعلاءِ في مَنْعِ الإِمالَةِ لأنَّ السببَ غيرُ ظاهرٍ، أَلا تَرى أنَّ سببَ الإِمالةِ الياءُ المُقدَّرةُ بخلافِ "غالب" و"طالب" و"قادم" فإنَّ حرفَ الاستِعلاءِ هنا مؤثِّرٌ لكونِ سببِ الإِمالةِ ظاهراً وهو الكسرة، وعلى هذا يُقال: كيف يُوَثِّرُ مع السببِ الظاهرِ ولم يؤثِّرْ معَ المُقدَّرِ وكان العكسُ أَوْلى؟ والجوابُ أنَّ الكَسْرةَ سببٌ منفصلٌ عن الحرْفِ المُمالِ ليس موجوداً فيه بخلاف الألفِ المُنقلِبة عن باءٍ فإنها نفسَها مقتضيةٌ للإِمالة، فلذلك لم يُقاومْها حرفُ الاستعلاء.
وأَمالَ الكِسائيُّ وحدَه {حَقَّ تُقَاتِهِ} آل عمران: 102، فخرجَ حمزةُ عن أصلِه، وكان الفرقُ أَنَّ "تُقاة" هذه رُسِمت بالياء فلذلك وافقَ حمزةُ الكسائيَّ عليه، ولذلك قرأ بعضُهم "تَقِيَّة" بوزن مطيَّة كما تقدم لظاهر الرسم، بخلافِ "حَقَّ تقاته"، وإنَّما أمعنتُ في سببِ الإِمالةِ هنا لأنَّ بعضَهم زَعم أنَّ إمالةَ هذا شاذٌّ لأجْلِ حرفِ الاسْتِعلاءِ، وأنَّ سيبويهِ حكى عن قومٍ أنَّهم يُميلون شيئًا لا يَجوزُ إمالتُه نحو: "رأيت عِرْقَى" بالإِمالة، وليس هذا من ذاك لِما تقدَّم لك من أنَّ سببَ الإِمالة في "عِرْقى" كسرةٌ ظاهرة.
وقوله: {مِنْهُمْ} متعلِّقٌ بـ "تتَّقوا"، أو بمحذوفٍ على أنَّه حالٌ مِن "تقاة" لأنَّه في الأَصلِ يَجوزُ أنْ يكونَ صِفةً لَها، فلمَّا قُدِّمَ نُصِبَ حالاً. هذا إذا لم تجعل "تُقاة" حالاً، فأمَّا إذا جَعَلْناها حالاً تَعيَّنَ أنْ يَتعلَّق "منهم" بالفعل قبله، ولا يجوز أنْ يَكون حالاً من "تقاة" لفسادِ المَعنى لأنَّ المخاطَبين لَيْسُوا مِن الكافرين.
قولُه: {نَفْسَهُ} مفعولٌ ثان لِحَذَّر؛ لأنَّه في الأصلِ مُتَعَدٍّ بِنَفْسِهِ لِواحدٍ فازدادَ بالتضعيفِ آخرَ، وقدَّرَ بعضُهم حَذْفَ مُضافٍ أي: عِقابَ نفسِه. فلا بُدَّ مِن شيءٍ تُحَذِّرُ منه كالعِقابِ والسَّطْوةِ، لأنَّ الذواتِ لا يُتَصَوَّرُ الحذرُ منها نفسِها، إنَّما يُتَصَوَّر مِن أفعالِها وما يَصْدُرُ عنها. وعَبَّرَ هنا بالنفسِ عن الذاتِ جَرْياً على عادةِ العربِ، كما قال الأعشى:
يَوْماً بأجودَ نائلاً منه إذا ................... نفسُ الجَبانِ تَجَهَّمَتْ سُؤَّالها
وقال بعضُهم: الهاء في "نفسَه" تعود على المصدرِ المفهوم من قوله: {لاَّ يَتَّخِذِ} أي: ويحذِّرُكم الله نفسَ الاتخاذ، والنفسُ عبارة عن وُجودِ الشيءِ وذاتِه.
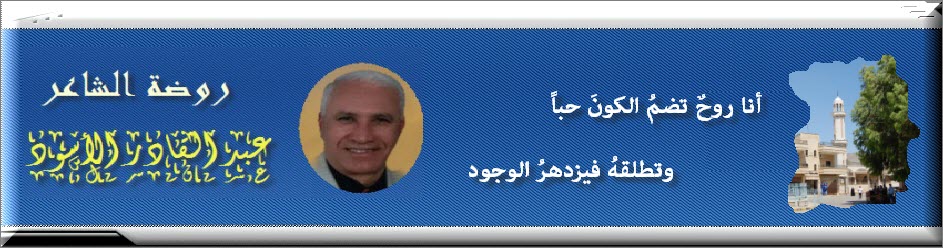


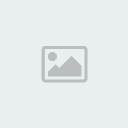
 المزاج
المزاج