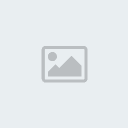إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ
(169)
قوله تعالى: {إنّما يأمركم} أي يوسوس لكم ، والوسوسة كلامٌ خفيٌّ تميل إليه النفس والطبع، والصوت الناعم، ومنه وسوسةُ الحِلِيِّ في المعصم، شبّه تسلُّطَ الشيطان عليهم بالآمر المطاع، وشُبِّهوا في قبولِهم الوسوسةَ وطاعتِهم له بالمأمور المطيع، وفيه رمزٌ إلى أنهم بمنزلة المأمورين المنقادين له تسفيهاً لرأيهم وتحقيراً لشأنهم. وينحصر ما يوسوس الشيطانُ به لابن آدم في ست مراتب:
المرتبة الأولى: الوسوسةُ بالكفرُ والشِركُ بالله ومعاداةُ رسولِه، فإذا ظفر بذلك من ابن آدم برد أنينه واستراح من تعبه، لأنّه حصّل منتهى أمنيتِه.
المرتبة الثانية: الوسوسة بالبدعة وهي أحبُّ إليه من الفسوق والمعاصي لأن المعصيةَ يُتابُ منها والبدعة لا يُتاب منها لأنّ صاحبَها يظنُّها صحيحةً فلا يَتوب.
المرتبة الثالثة: الوسوسة بالكبائرُ على اختلاف أنواعها.
المرتبة الرابعة: الوسوسةُ بالصغائرُ التي إذا اجتمعت صارت كبيرة، والكبائر ربما أهلكت صاحبَها كما قال عليه الصلاةُ والسلام: ((إيّاكم ومحقَّرات الذنوب)) فإنّ مَثَلَ ذلك مثلُ قوم نَزَلوا بفلاة من الأرض، فجاء كلُّ واحدٍ بعود حطب حتى أوقدوا ناراً عظيمة وطبخوا وشبعوا.
المرتبة الخامسة: إشغالُه بالمباحات التي لا ثوابَ فيها ولا عقاب، بل عقابها مايفوته من ثوابِ باشتغاله بها.
المرتبة السادسة: أنْ يَشغَلَه بالعمل المفضول عما هو أفضل منه ليُزيح عنه الفضيلة ويفوته ثواب العمل الفاضل، ويجرُّه من الأفضل السهل إلى الفاضل الأشقِّ لحصول النفرة عن الطاعة بالكلية.
وإنّما خلق اللهُ إبليسَ ليميزَ به الخبيثَ من الطيّب، فخلق الله الأنبياء عليهم السلامُ ليقتدي بهم السعداء، وخلق إبليسَ ليقتدي به الأشقياء، فيظهر الفرق بينهما، فإبليسُ دلالٌ وسِمسارٌ على النارِ، وبضاعتُه الدنيا، ولمّا عرضها على الكافرين قيلَ: ما ثمنُها قال: تركُ الدين، فقالوا له: أعطِنا مذاقةً منها. فقال: أعطوني رهناً. فأعطوه سمعَهم وأبصارَهم، ولذا يحب أربابُ الدنيا استماعَ أخبارِها ومشاهدةَ زينتِها لأنّ سمعَهم وبصرَهم رهنٌ عندَ إبليس، فأعطاهم المذاقة بعد قبض الرهن فاشتروها بالدين، ولم يسمعوا من الزهاد عيب الدنيا، ولم يبصروا قبائحها، بل استحسنوا زخارفَها ومتاعَها، فلذلك قيل: حُبُّكَ الشيءَ يُعمي ويُصم. وتركها الزاهدون وأعرضوا عنها. قال الحسن البَصْريُّ ـ رحمه الله ـ الحلالُ الطيِّبُ ما لا سؤالَ فيه يوم القيامة، وهو ما لا بدَّ منه.
وقوله: {بالسوء} السوء كلُّ ما ساءك فى عاقبتك، ويطلق على جميع المعاصى سواء أكانت من أعمال الجوارح أو أعمال القلوب لاشتراكها فى أنّها تسوء صاحبها وتحزنه. وَهُوَ مَصْدَرُ سَاءَهُ يَسُوءُهُ سُوءًا وَمُسَاءَةً إِذَا أَحْزَنَهُ. وَسُؤْتُهُ فَسِيءَ إِذَا أَحْزَنْتَهُ فَحَزِنَ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: "سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا".
وقال الشاعر:
إِنْ يَكُ هَذَا الدَّهْرُ قَدْ سَاءَنِي ... فَطَالَمَا قَدْ سَرَّنِي الدَّهْرُ
الْأَمْرُ عِنْدِي فِيهِمَا وَاحِـــــدٌ ... لِـذَاكَ شُكْرٌ وَلِذَاكَ صَبْرُ
و"الفحشاءُ" مصدرٌ من الفُحْش، كالبأساء من البأْسِ. وهو من عطف الخاص على العام، أي أقبح أنواع المعاصي وأعظمها مساءة، فالزنى فاحشة والبخل فاحشة وكلّ فَعْلَةٍ قبيحةٍ فاحشة. وأصل الفحش مجاوزة القدر في كلِّ شىءٍ، والفُحْشُ قُبْحُ المنظر، قال امرؤ القيس:
وجِيدٍ كجيدٍ الرِّئْمِ ليس بفاحِشٍ .. إذا هي نَصَّتْهُ ولا بِمُعَطَّلِ
وقَالَ آخر:
وَجِيدٍ كَجِيدِ الرِّيمِ لَيْسَ بِفَاحِشٍ ......................
ثمّ تُوُسِّع فيه حتى صارَ يُعَبَّرُ به عن كلِّ مستقبَحٍ فاسْتُعْمِلَتِ فِيمَا يُقْبَحُ مِنَ الْمَعَانِي. وَالشَّرْعُ هُوَ الَّذِي يُحَسِّنُ وَيُقَبِّحُ، فَكُلُّ مَا نَهَتْ عَنْهُ الشَّرِيعَةُ فَهُوَ مِنَ الْفَحْشَاءِ. وَإِنَّ كُلَّ مَا فِي الْقُرْآنِ مِنْ ذِكْرِ الْفَحْشَاءِ فَإِنَّهُ الزِّنَى، إِلَّا قَوْلَهُ: "الشَّيْطانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشاءِ" فَهي هنا مَنْعُ الزَّكَاةِ. ولذلك قِيلَ: السُّوءُ مَا لَا حَدَّ فِيهِ، وَالْفَحْشَاءُ مَا فِيهِ حَدٌّ.
قَوْلُهُ تَعَالَى: "وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ" أي مَا حَرَّمُوا مِنَ الْبَحِيرَةِ وَالسَّائِبَةِ وَنَحْوِهَا مِمَّا جَعَلُوهُ شَرْعًا. وَأَنْ تَقُولُوا" فِي مَوْضِعِ خَفْضٍ عَطْفًا على قوله تعالى: "بِالسُّوءِ وَالْفَحْشاءِ". تقديرُه: "وبأنْ تقولوا" ويحتملُ موضعُها النصبَ.
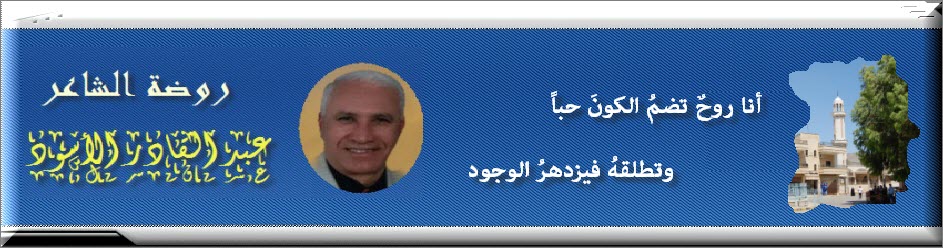


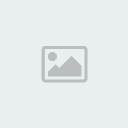
 المزاج
المزاج