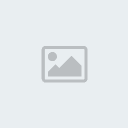وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ
عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ
بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (109)
هذه الآية الكريمة تتناول أحداثاً وقعت بعد غزوة أحد ، وفي غزوة أُحُدٍ طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، من الرماة ألاّ يُغادروا مواقعَهم عند سفح الجبل سواءً انتصر المسلمون أو انهزموا ، فلمّا بدأت بوادر النصر طمع الرماة في الغنائم ، فخالفوا أمرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم فهزمهم الله ، ولكنّ الكفّار لم يحقّقوا نصراً حاسماً لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ثبت في أرض المعركة وحوله نفر من أصحابه ، ثم إن الذين انهزموا من المسلمين عادوا للالتحاق بالمعركة أما الكفّار فقد رجعوا بعد المعركة عائدين إلى مكة ، حتى أنّ المسلمين عندما خرجوا للقائهم في اليوم التالي لم يجدوا أحداً . واستغلّ يهود المدينة هذا الحدث . . وقالوا لحذيفة بن اليمان وعمّار بن ياسر وغيرهما: لماذا إنهزمتم إن كنتم مؤمنين حقاً ، فارجعوا إلى ديننا واتركوا دين محمد ، فقال لهم حذيفة: ماذا يقول دينكم في نقض العهد؟ يقصد ما تقوله التوراة في نقض اليهود لعهودهم مع الله ومع موسى ، ثم قال أنا لن انقض عهدي مع محمد ما حييت ، أما عَمّار فقال: لقد آمنت بالله ربّاً وآمنت بمحمد رسولاً وآمنت بالكتاب إماماً وآمنت بالكعبة قبلةً وآمنت بالمؤمنين إخوةً وسأظلّ على هذا ما حييت .
وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قاله حذيفة وعمّار بن ياسر ، فسُرّ بذلك ولكن اليهود كانوا يستغلون ما حدث في أحد ليهزموا العقيدة الإيمانية في قلوب المسلمين كما استغلوا تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة ليهزوا الإيمان في القلوب وقالوا إذا كانت القبلة تجاه بيت المقدس باطلة فلماذا اتجهتم إليها ، وإذا كانت صحيحة فلماذا تركتموها ، فنزل قول الله تعالى: {وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الكتاب} .
وانظر إلى دقة التعبير القرآني في قوله تعالى: {من أَهْلِ الكتاب} فلو أن الله جلّ جلالُه حكم على كلِّ أهل الكتاب لسدَّ الطريقَ أمامَ القِلّة من يريد الإيمان منهم ، لأن الله تعالى قال: { وَدَّ كَثِيرٌ .. } وهم طائفة من أحبار اليهود منهم: فنحاص بن عازوراء وزيد بن قيس ونفر من اليهود فيما ذكر من حديث طويل عن ابن عباس رضي الله عنهما.
{وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الكتاب لَوْ يَرُدُّونَكُم} تقدم الكلامُ في "لو" عندَ قوله تعالى: {يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ} البقرة: 96 فهي إمّا مصدريّة وتكون بذلك مفعولَ "يَوَدُّ" أي: وَدَّ كثيرٌ رَدَّكم . ويمكن أن يكون جوابها محذوفاً تقديرُه: لو يَرُدُّونَكم كفاراً لَسُرُّوا ، أو فرحوا بذلك ، و"لو"حرفٌ لما كان سيقعُ لوقوعِ غيرِه وهي متعدية لمفعولين بمعنى صَيَّر، فضميرُ المخاطبين مفعولٌ أَوَّلُ ، و"كفاراً" مفعولٌ ثانٍ ، ومِنْ مجيء رَدَّ بمعنى صَيَّر قول الشاعر:
رمى الحَدَثانُ نسوةَ آلِ حربٍ ............... بمِقْدارٍ سَمَدْنَ له سُمودا
فَرَدَّ شعورَهُنَّ السُّودَ بِيضاً ............... وَرَدَّ وجوهَهُنَّ البِيضُ سُودا
وجَعَلَ بعضهم "كفاراً" حالاً من ضميرِ المفعولِ على أنَّها المتعديةُ لواحدٍ ، وهو ضعيفٌ لأنَّ الحالَ يُسْتَغْنى عنها غالباً ، وهذا لا بُدَّ منه . و"مِنْ بعدِ" متعلِّقٌ بيَرُدُّونكم ، و"مِنْ" لابتداءِ الغاية .
قوله: {حَسَداً} نصبٌ على المفعولِ له، وفيه الشروطُ المجوِّزة لنصبِه، والعاملُ فيه "وَدَّ" أي: الحاملُ على ودَادَتِهم رَدَّكم كفاراً حَسَدُهم لكم . وجَوَّزوا فيه وجهين آخرين ، أحدُهما: أنه مصدرٌ في موضعِ الحالِ، وإنما لم يُجْمَعْ لكونِه مصدراً، أي: حاسِدِين ، وهذا ضعيفٌ؛ لأنَّ مجيءَ المصدرِ حالاً لا يَطَّرِدُ . الثاني: أنه منصوبٌ على المصدريةِ بفعلٍ مقدَّرٍ من لفظِه أي يَحْسُدونكم حَسَداً ، والأولُ أظهرُ الثلاثة .
قوله: {مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ} في هذا الجارِّ ثلاثةُ أوجهٍ ، أحدُها ، أنَّه متعلِّقٌ بوَدَّ ، أي: وَدُّوا ذلك مِنْ قِبَلِ شَهَواتِهم لا من قبلِ التَدَيُّنِ ، و"مِنْ" لابتداءِ الغايةِ. الثاني: أنه صفةٌ لـ "حَسَداً"، فهو في محلِّ نصبٍ، ويتعلَّقُ بمحذوفٍ أي: حَسَداً كائناً مِنْ قِبَلهم وشهوتِهم، ومعناه قريبٌ من الأول . الثالث: انه متعلِّقُ بيردُّونكم و"مِنْ" للسببية أي: يكونُ الردُّ مِنْ تِلْقائِهم وجِهَتِهم وبإغوائهم .
قوله: "مِّن بَعْدِ مَا" متعلِّقٌ بـ "وَدَّ"، و"مِنْ" للابتداءِ ، أي إنَّ ودَادَتَهم ذلك ابتدأتْ من حينِ وضوحِ الحقِّ وتبيُّنِه لهم ، فكفرُهم عنادٌ و"ما" مصدريةٌ أي: مِنْ بعدِ تبيُّنِ الحقِّ . والحَسَدُ: تمنِّي زوالِ نعمةِ الإِنسانِ ، المصدرُ: حَسَدٌ وحَسَادَة . والصَّفْحُ قريبُ من العفو ، مأخوذٌ من الإِعراض بِصَفْحَةِ العنق ، وقيل : معناهُ التجاوزُ ، مِنْ تَصَفَّحْتُ الكتاب أي: جاوزت ورقَه ، والصَّفوح: من أسماء الله ، والصَّفُوح أيضاً: المرأةُ تَسْتُر وجهَها إعراضاً ، قال:
صَفُوحٌ فما تَلْقاكَ إلاَّ بِحِيلةٍ ..........فمَنْ ملَّ منها ذلك الوصلَ مَلَّتِ
قوله:{فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره} أي: اعفوا عن أهل الكتاب حتى يحدث الله أمراً. فأحدث الله بعد فقال: {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر .. وهم صاغرون} وقال قتادة نسختها: {اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} .
قوله:{ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ}القدير: القوي. فمعنى الآية: إن الله على كل ما يشاء قدير ، إن شاء انتقم منهم بعنادهم ربهم، وإن شاء هداهم لما هداكم الله له من الإيمان ، لا يتعذر عليه شيء أراده ، ولا يتعذر عليه أمر شاء قضاءه ، لأن له الخلق والأمر.
وقد صرح جلّ ثناؤه ، بأن خطابه بجميع هذه الآيات من قوله: {يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا} وإن صرف الكلام إلى خطاب النبي صلى الله عليه وسلم ، إنما هو خطاب منه للمؤمنين من أصحابه ، وعتاب منه لهم ، ونهي عن انتصاح اليهود ونظرائهم من أهل الشرك وقبول آرائهم في شيء من أمور دينهم ، ودليل على أنه كان منهم من استعمل في خطابه ومسألته رسول الله صلى الله عليه وسلم الجفاء ، وما لم يكن لهم استعماله معه ، تأسّياً باليهود في ذلك أو ببعضهم . فقال لهم ربهم ناهياً عن استعمال ذلك: لا تقولوا لنبيكم صلى الله عليه وسلم كما تقول له اليهود: "راعنا"، ولكن قولوا:"انظرنا واسمعوا"، فإنّ أذى رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر بي ، وجحود لحقّي الواجب عليكم في تعظيمه وتوقيره ، لأن تعظيم الرسول من تعظيم مرسله ، والعكس بالعكس ، ولمن كفر به عذاب أليم ; فإن اليهود والمشركين ما يودون أن ينزل عليكم من خير من ربكم، ولكن كثيراً منهم ودّوا أنهم يردونكم من بعد إيمانكم كفاراً، حسداً من عند أنفسهم لكم ولنبيِّكم محمد صلى الله عليه وسلم ، من بعد ما تبين لهم الحق في أمر محمد ، وأنه نبيٌّ إلى الخلق كافة .
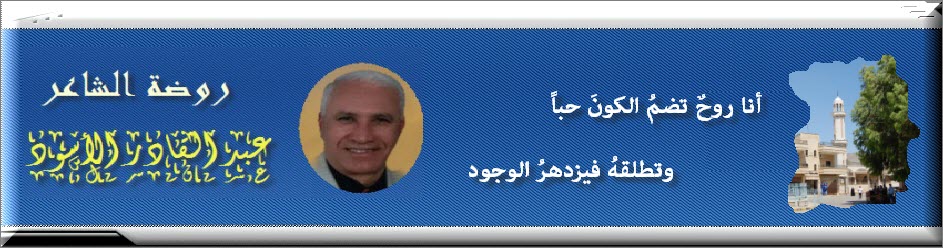


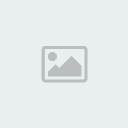
 المزاج
المزاج