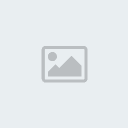1ـ أهميتها وفائدتها وآثارها:
إن للصحبة أثراً عميقاً في شخصية المرء وأخلاقه وسلوكه، والصاحب
يكتسب صفات صاحبه بالتأثر الروحي والاقتداء العملي، والإنسان
اجتماعي بالطبع لا بد أن يخالط الناس ويكون له منهم أخلاء وأصدقاء
؛ فإن اختارهم من أهل الفساد والشر والفسوق والمجون انحدرت أخلاقه،
وانحطت صفاته تدريجياً دون أن يشعر، حتى يصل إلى حضيضهم ويهوي إلى
دركهم.
أما إذا اختار صحبة أهل الإيمان والتقوى والاستقامة والمعرفة بالله
تعالى فلا يلبث أن يرتفع إلى أوج علاهم، ويكتسب منهم الخُلق
القويم، والإيمان الراسخ، والصفات العالية، والمعارف الإلهية،
ويتحرر من عيوب نفسه، ورعونات خُلُقِهِ. ولهذا تُعرف أخلاق الرجل
بمعرفة أصحابه وجلسائه.
إذا كنتَ في قوم فصاحب خيارَهمولا تصحب الأردى فترْدَى مع الرديعن
المرء لا تسأل وسل عن قرينهفكل قرين بالمقارن يقتدي وما نال
الصحابة رضوان الله عليهم هذا المقام السامي والدرجة الرفيعة بعد
أن كانوا في ظلمات الجاهلية إلا بمصاحبتهم لرسول الله صلى الله
عليه وسلم ومجالستهم له. وما أحرز التابعون هذا الشرف العظيم إلا
باجتماعهم بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وبما أن رسالة سيدنا محمد عليه السلام عامة خالدة إلى قيام الساعة،
فإن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وُرّاثاً من العلماء العارفين
بالله تعالى، ورثوا عن نبيهم العلم والخُلق والإيمان والتقوى،
فكانوا خلفاء عنه في الهداية والإرشاد والدعوة إلى الله، يقتبسون
من نوره ليضيؤوا للإنسانية طريق الحق والرشاد، فمَنْ جالسهم سرى
إليه من حالهم الذي اقتبسوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم،
ومَنْ نصرهم فقد نصر الدين، ومن ربط حبله بحبالهم فقد اتصل برسول
الله صلى الله عليه وسلم.
ومن استقى من هدايتهم وإرشادهم فقد استقى من نبع رسول الله صلى
الله عليه وسلم.
هؤلاء الوراث هم الذين ينقلون للناس الدين، مُمَثَّلاً في سلوكهم،
حيَّاً في أحوالهم، واضحاً في حركاتهم وسكناتهم، هم من الذين عناهم
رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله:
"لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى
يأتي أمر الله وهم كذلك" [أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الإمارة،
وأخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة بلفظ
آخر، وأخرجه الترمذي في كتاب الفتن، وابن ماجه في كتاب السنة].
لا ينقطع أثرهم على مر الزمان، ولا يخلو منهم قطر.
وهؤلاء الوراث المرشدون صحبتهم ترياق مجرب، والبعد عنهم سم قاتل،
هم القوم لا يشقى بهم جليسهم ؛ مرافقتهم هي العلاج العملي الفعَّال
لإصلاح النفوس، وتهذيب الأخلاق، وغرس العقيدة، ورسوخ الإيمان، لأن
هذه أُمور لا تُنال بقراءة الكتب، ومطالعة الكراريس، إنما هي خصال
عملية وجدانية، تُقتبس بالاقتداء، وتُنال بالاستقاء القلبي والتأثر
الروحي.
ومن ناحية أخرى، فكل إنسان لا يخلو من أمراض قلبية، وعلل خفية لا
يدركها بنفسه، كالرياء والنفاق والغرور والحسد، والأنانية وحب
الشهرة والظهور، والعجب والكبر والبخل... بل قد يعتقد أنه أكمل
الناس خُلقاً، وأقومهم ديناً، وهذا هو الجهل المركب، والضلال
المبين.
قال تعالى:
{قُلْ هل نُنَبِّئُكم بالأخسرين أعمالاً الذين ضلَّ سعيهم في
الحياة الدنيا وهم يحسبون أنَّهم يُحسنون صنعاً} [الكهف: 103ـ104].
فكما أن المرء لا يرى عيوب وجهه إلا بمرآة صافية مستوية، تكشف له
عن حقيقة حاله، فكذلك لا بد للمؤمن من أخ مؤمن مخلص ناصح صادق،
أحسن منه حالاً، وأقوم خُلقاً، وأقوى إيماناً، يصاحبه ويلازمه،
فيريه عيوبه النفسية، ويكشف له عن خفايا أمراضه القلبية إما بقاله
أو بحاله.
ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: "المؤمنُ مِرآةُ المؤمن" [رواه أبو
داود عن أبي هريرة رضي الله عنه. ورواه البخاري في "الأدب المفرد"
وقال الزين العراقي: إسناده حسن. "فيض القدير" ج6/ص252].
وعلينا أن نلاحظ أن المرايا أنواع وأشكال ؛ فمنها الصافية
المستوية، ومنها الجرباء التي تُشوِّهُ جمال الوجه، ومنها التي
تُكبِّر أو تُصغِّر.
وهكذا الأصحاب ؛ فمنهم الذي لا يريك نفسك على حقيقتها، فيمدحك حتى
تظن في نفسك الكمال، ويُدخل عليك الغرور والعجب، أو يذمك حتى تيأس
وتقنط من إصلاح نفسك. أما المؤمن الكامل فهو المرشد الصادق الذي
صقلت مرآته بصحبة مرشد كامل، ورث عن مرشد قبله وهكذا حتى يتصل
برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المرآة التي جعلها الله تعالى
المثل الأعلى للإنسانية الفاضلة ؛ قال تعالى:
{لقد كان لكم في رسول الله أُسوةٌ حسنةٌ لِمَنْ كان يرجو الله
واليومَ الآخرَ وذكرَ اللهَ كثيراً} [الأحزاب: 21].
فالطريق العملي الموصل لتزكية النفوس والتحلي بالكمالات الخلقية هو
صحبة الوارث المحمدي والمرشد الصادق الذي تزداد بصحبته إيماناً
وتقوىً وأخلاقاً، وتشفى بملازمته وحضور مجالسه من أمراضك القلبية
وعيوبك النفسية، وتتأثر شخصيتك بشخصيته التي هي صورة عن الشخصية
المثالية، شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ومن هنا يتبين خطأ من يظن أنه يستطيع بنفسه أن يعالج أمراضه
القلبية، وأن يتخلص من علله النفسية بمجرد قراءة القرآن الكريم،
والاطلاع على أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وذلك لأن الكتاب
والسنة قد جمعا أنواع الأدوية لمختلف العلل النفسية والقلبية، فلا
بد معهما من طبيب يصف لكل داء دواؤه ولكل علة علاجها [تسرع بعض
القراء ففهم هذه العبارة على غير مرادها، وظن أننا نقصنا من أهمية
القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وزهَّدنا في تلاوتهما،
والحقيقة أن رجال التصوف هم أكثر الناس تعظيماً لهما وتمسكاً بهما.
ففي عبارة: (بمجرد قراءة القرآن الكريم...) بيان إلى أنه لا يكفي
الاقتصار على قراءة القرآن الكريم والسنة الشريفة بل لا بد أيضاً
من الفهم والعمل، ومن المعلوم أن الكتاب والسنة يدعوان للصحبة
الصالحة كما سنوضحه في بحث (الدليل على أهمية الصحبة من الكتاب
والسنة). وفي عبارة: (فلا بد معهما...) تصريح واضح بلزوم قراءة
القرآن الكريم والسنة الشريفة، ثم يضاف إلى ذلك صحبة المرشدين
الذين يزكون النفوس ويحضون الناس على قراءة وتطبيق الكتاب والسنة].
فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطبب قلوب الصحابة ويزكي
نفوسهم بحاله وقاله
فمن ذلك ما حدث مع الصحابي الجليل أُبيّ بن كعب رضي الله عنه قال: (كنت
في المسجد، فدخل رجل فصلى، فقرأ قراءة أنكرتها عليه، ثم دخل
آخر فقرأ سوى قراءة صاحبه، فلما قضيا الصلاة دخلنا جميعاً على رسول
الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: إن هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه،
فدخل آخر فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه. فأمرهما رسول الله صلى الله
عليه وسلم فقرآ، فحَسَّنَ النبي شأنهما، فسقط في نفسي من التكذيب
ولا إذ كنت في الجاهلية، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما
قد غشيني ضرب في صدري، ففضت عرقاً، وكأني أنظر إلى الله عز وجل
فَرَقاً) [أخرجه مسلم في صحيحه في باب بيان القرآن على سبعة أحرف].
ولهذا لم يستطع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطببوا
نفوسهم بمجرد قراءة القرآن الكريم، ولكنهم لازموا مستشفى رسول الله
صلى الله عليه وسلم ؛ فكان هو المزكي لهم والمشرف على تربيتهم، كما
وصفه الله تعالى بقوله:
{هو الذي بعثَ في الأمّيّين رسولاً منهم يتلو عليهم آياته
ويُزكّيهم ويُعلّمهم الكتابَ والحِكمةَ} [الجمعة: 2].
فالتزكية شيء، وتعليم القرآن شيء آخر، إذ المراد من قوله تعالى:
{يزكيهم} يعطيهم حالة التزكية، ففرقٌ كبير بين علم التزكية وحالة
التزكية كما هو الفرق بين علم الصحة وحالة الصحة، والجمع بينهما هو
الكمال.
وكم نسمع عن أناس متحيرين يقرؤون القرآن الكريم، ويطلعون على
العلوم الإسلامية الكثيرة، ويتحدثون عن الوساوس الشيطانية، وهم مع
ذلك لا يستطيعون أن يتخلصوا منها في صلاتهم!.
فإذا ثبت في الطب الحديث أن الإنسان لا يستطيع أن يطبب نفسه بنفسه
ولو قرأ كتب الطب، بل لا بد له من طبيب يكشف خفايا علله، ويطلع على
ما عمي عليه من دقائق مرضه، فإن الأمراض القلبية، والعلل النفسية
أشد احتياجاً للطبيب المزكي، لأنها أعظم خطراً، وأشد خفاء وأكثر
دقة.
ولهذا كان من المفيد عملياً تزكية النفس والتخلص من عللها على يد
مرشد كامل مأذون بالإرشاد، قد ورث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
العلم والتقوى وأهلية التزكية والتوجيه.
وها نحن نورد لك يا أخي من كتاب الله تعالى، وسنة رسوله صلى الله
عليه وسلم، ومن أقوال علماء الشريعة من المحدثين، والفقهاء،
والهداة المرشدين العارفين بالله ما يثبت أهمية صحبة الدالين على
الله الوارثين عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وما في ذلك من الآثار
الحسنة، والنتائج الطيبة.
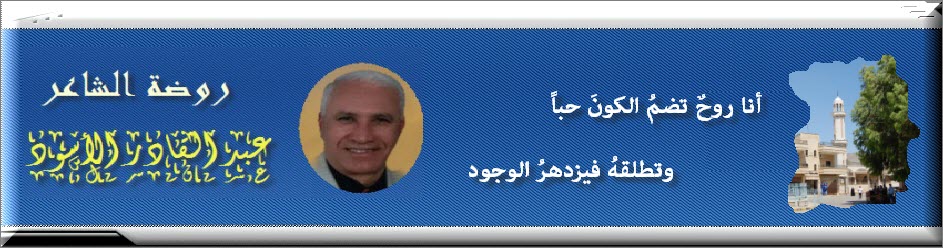


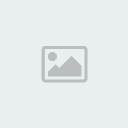
 المزاج
المزاج